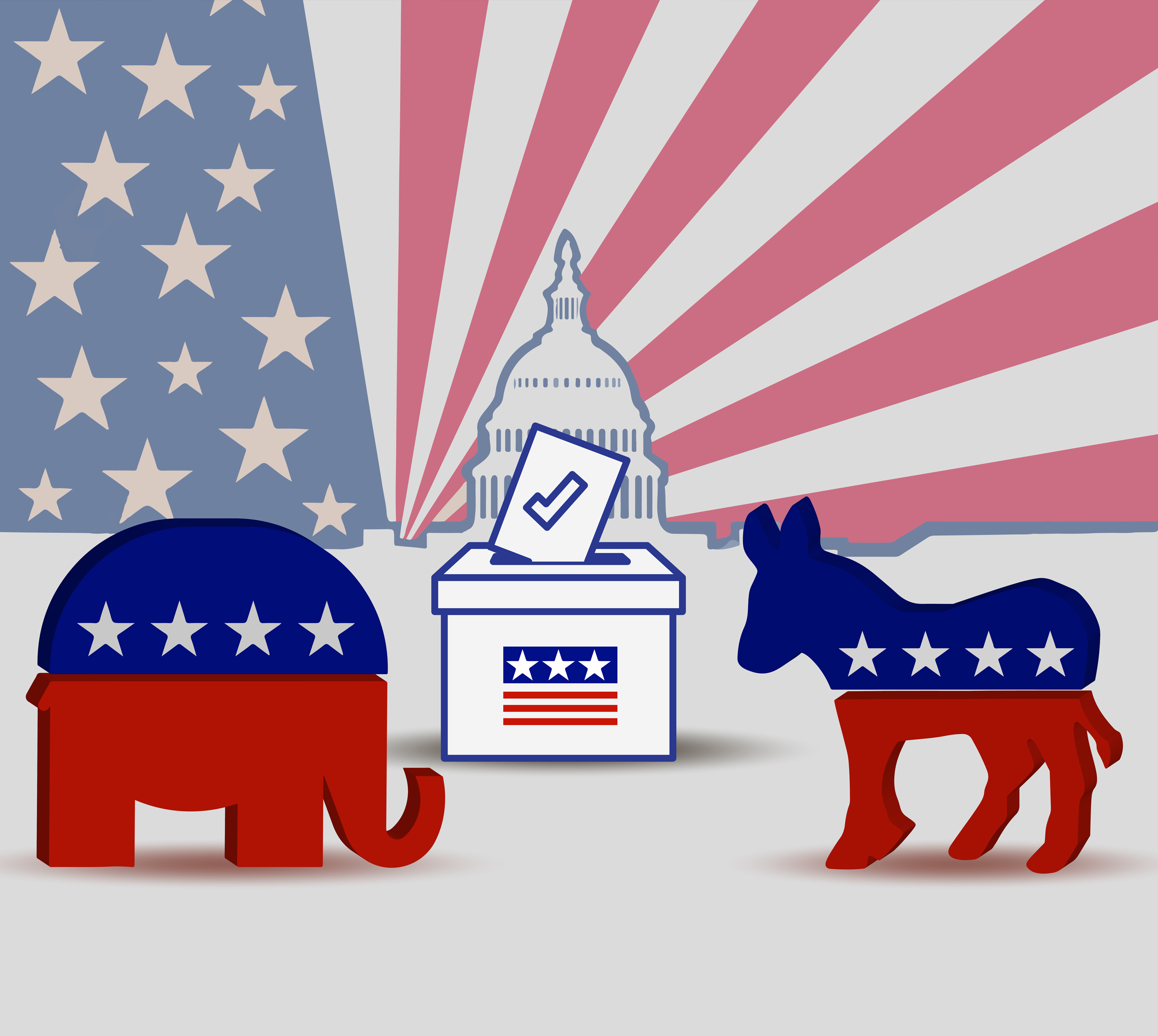يتسمر العالم كلّ أربع سنوات أمام وسائل الإعلام؛ الشاشات منها على وجه الخصوص: الثابتة والمحمولة، التقليدية أو الذكية، لتتبع الحدث المنتظر، متسلحين بالإحصاءات من جهة وبالتنبؤات والتوقعات من جهة ثانية، بعضهم متحمس، وبعضهم الآخر يُبدي عدم الاكتراث، والكل يترقب النتائج.
ليس الحديث هنا عن كأس العالم أو الألعاب الأولمبية، بل عن سباق "الحمار والفيل" نحو المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.
الحمار والفيل، كما بات معروفاً عند الأغلبية، هما على التوالي شعارا الحزبيْن الأمريكييْن: "الديمقراطي" و"الجمهوري"، اللذَيْن يسيطران منذ عقود على كلّ الانتخابات الأمريكية وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية. شعار "الحمار" أقدم من صاحبه "الفيل" إذ يعود إلى حملة الانتخابات الرئاسية لعام 1828، عندما أطلق معارضو المرشح أندرو جاكسون عليه اسم "جاكاس" (لقرب اللفظ من اسمه)، وهي كلمة بقصد الإهانة وتعني "الحمار"، وبدل الشعور بالغضب أو الاستياء؛ ما كان من جاكسون - الذي أصبح سابع رؤساء أمريكا وأول رئيس "ديمقراطي" لها - إلا أن بدأ بتضمين صور "حمار" في حملته الانتخابية.
أما أول ظهور لـ "الفيل الجمهوري" فكان عام 1874 - أي بعد عشرين عاماً من تأسيس الحزب على يد توماس ناست Thomas Nast - في رسم كاريكاتوري في جريدة هاربر الأسبوعية Harper's Weekly. وقد استخدم الفيل للدلالة على حجم الحزب ونفوذه الكبيريْن. يعدُّ ناست أبا الكاريكاتور السياسي الحديث وأحد أشد الساخرين في أمريكا، وإليه ترجع صور "سانتا كلوز" و"العم سام" كما نعرفها اليوم، والتي تشكل مع "الفيل" الذي اخترعه و"الحمار" الذي كان المساهم الأكبر في انتشاره، الدعامة الأساسية للثقافة البصرية الأمريكية.
إن سيطرة "الحمار والفيل" على المشهد الانتخابي الأمريكي لا تعني أنهما الحزبان الوحيدان في أمريكا، بل توجد عدة أحزاب أمريكية أخرى مثل حزب الخضر، وحزب الاستقلال الأمريكي، وحزب الدستور، والحزب التحرري (الليبرتاري)، وحزب الإصلاح، والحزب الشيوعي الأمريكي، وغيرها؛ لكن نظام الانتخاب غير المباشر القائم على "المجمع الانتخابي"، ومبدأ "الفائز يحصد كلّ الأصوات" السائد في كلّ الولايات (باستثناء نبراسكا وماين) هو الذي خلق حالة الاستقطاب هذه والتي امتدت لتشمل أغلب المجتمع الأمريكي. عندما يضع المقترع الأمريكي الورقة في الصندوق في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، فهو لا ينتخب رئيس بلاده فحسب، بل ينتخب نائب الرئيس أيضاً، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب الأمريكي البالغ عددهم 435، و35 من أعضاء مجلس الشيوخ الـ 100 (كان 12 منهم للديمقراطيين و23 للجمهوريين). في ظل الثنائية الحزبية القائمة في أمريكا، ستكون السيطرة على مجلس الشيوخ مصيرية للغاية إذ إنه يؤثر على السياسة الأمريكية بما يتجاوز الدور التشريعي. كما أن سيطرة أحد الحزبين على مجلس النواب ومجلس الشيوخ والرئاسة تمنحه قدرة نادرة على تمرير القوانين دون الاكتراث كثيراً بآراء الحزب الآخر.
يصوّت الأمريكيون في هذه الانتخابات أيضاً على موقع بلادهم بين القوى العظمى، وموقفها من الاضطرابات الدولية المتزايدة، وعلى استعدادها لمواجهة المتربصين المستعدين لاقتناص بقعة أو موطئ قدم يتمكنون عبره من تقويض المصالح الأمريكية، ويصوتون على علاقتهم مع إيران التي ما توقفت تعيث فساداً في استقرار الشرق الأوسط، وعلى تحالفات أمريكا الاستراتيجية هناك، ويصوتون أيضاً على طبيعة دبلوماسيتهم التجارية، وانتعاش اقتصادهم، وعلى كلّ المزايا التي حققوها من "قيادة العالم".
على الرغم من أنَّه نادراً ما يتم التطرق إلى السياسة الخارجية في الحملات الانتخابية، إلا أن "مناسبة" الانتخابات الرئاسية الأمريكية تتحول إلى حدث إعلامي عالمي، ويتابع الناس التطورات اليومية عن كثب، بدءاً من الانتخابات التمهيدية إلى ما بعد يوم الاقتراع (أول ثلاثاء بعد أول اثنين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر)، فهي ليست مجرد انتخابات رئاسية، بل هي تنصيب لـ "أقوى زعماء العالم" الذي سيتربع على عرش أكبر اقتصاد وأضخم قدرات عسكرية وأحدث وأدق تكنولوجيا وأوزن قوة سياسية في العالم بأسره.
تعدُّ الانتخابات الرئاسية الأمريكية حدثاً عالمياً بامتياز، وقد يتجاوز اهتمام بعض الشعوب بها اهتمام الأمريكيين أنفسهم، فمثلاً أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث حول انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2008 أن 83% من الأمريكيين يهتمون بشدة بالانتخابات، في حين أبدى 84% من الأستراليين اهتماماً مماثلاً!
يتابع الجميع بدءاً من الناس العاديين وصولاً إلى العلماء وصانعي السياسات والنشطاء هذه الانتخابات لأن ما يفعله الرئيس القادم، أو ما لا يفعله، خلال السنوات الأربع المقبلة سيكون له تأثير عميق على كلّ الأحداث العالمية من تغير المناخ إلى الأمن العالمي، ومن سباق التكنولوجيا على الأرض إلى سبق التسلح في الفضاء؛ ولأنها - أي الانتخابات - مؤثرة في العلاقات الدولية ككل، وفي علاقة أمريكا مع بلادهم وبالتالي مستقبل بلادهم في منظومة العلاقات الدولية؛ وهي مهمة أيضاً من ناحية التأثيرات الاقتصادية، وبخاصة على آفاق التجارة العالمية نظراً إلى أهمية الدور الاقتصادي الأمريكي بالإضافة إلى دور الولايات المتحدة في الأمن العالمي ومكافحة الإرهاب.
يراقب العالم صراع الحمار والفيل محاولاً الحصول على فكرة معمّقة عن النظام السياسي الأمريكي ودينامياته، أو استيضاح خلفيات النظرة الأمريكية للعالم، أو استشفاف سمات وطبيعة شخصية المرشحين ومقاربتهما المتوقعة لقيادة العالم، هل ستتفرد أمريكا أم ستشارك، هل ستقود العالم بالفعل أم ستنكفئ وتتبع نهج "أمريكا أولاً"؟
الكل له رأيٌّ في الانتخابات الأمريكية
من الطبيعي في هذا السياق ألا تحمل آراء الفواعل الدولية أي وزن في انتخابات دولة أخرى خاصة في الحالة الأمريكية، إلا أن المستغرب ألا يكون لها تأثير على قرارات الرئيس المنتخب وإدارته مستقبلاً، والكل يعلم مدى تأثير جماعات الضغط على صناعة السياسة الخارجية الأمريكية. والإشارة هنا تحديداً إلى وضع الدول العربية.
إذ يُعاب على بعض الدول العربية تفضيلها هذا المرشح أو ذاك، بل وتصل الاتهامات حد التخوين عندما تدعم دول عربية الرئيس دونالد ترامب الذي وقف من جهة ضد مشروع الهيمنة الإيراني، ووقف من جهة ثانية مع مشروع بناء السلام في المنطقة. ليست المشكلة في أن تدعم أي دولة عربية مرشحاً دون آخر، أو أن يكون لها تفضيل مبني على مصالحها الشخصية، بل العكس، تكمن المشكلة في عدم وضع خطط تهدف إلى تعزيز العلاقات وتطويرها في حال فاز المرشح، وخطط بديلة لها الهدف ذاته في حال فاز المرشح الآخر.
هل استعد العرب لفوز أي من دونالد ترامب أو جو بايدن؟ هل هناك لوبي عربي قادر أن يُوجِد مكاناً للمصلحة العربية على خارطة الإدارة الأمريكية جمهورية كانت أم ديمقراطية؟ ولماذا لم يستطع العرب الوصول إلى أي نوع من الإجماع، وبالتالي القدرة على تكوين أي جماعة ضغط تحولهم من منفعل ومتأثر بالسياسات الدولية إلى فاعل حقيقي فيها؟ مع التأكيد على أن العالم العربي و"الشرق الأوسط" بالغا الأهمية في السياسة الخارجية الأمريكية، وأياً كان الرئيس فهو لن يكون قادراً على تجاهل "المصالح الاستراتيجية" للولايات المتحدة هناك. لكننا حتى اليوم لم نستفد من هذا التفصيل المهم جداً.
كذلك لم نستفد - كعرب - من الأعداد الكبيرة للجالية العربية والمسلمة الموجودة في أمريكا، حيث تكاد تتجاوز بعددها الجالية اليهودية لتكون أكبر أقلية دينية في الولايات المتحدة، ما يضع بين يديها أوراق تأثير مهمة، يمكن أن تزداد قوة إذا حصلت على دعم عربي أكبر. لكن وبالرغم من ذلك؛ فإن البعض في هذه الجالية ما زال يعاني من "الإسلاموفوبيا"، ومن وسْمهم بصفة الإرهاب، ومن الصور النمطية والأحكام المسبقة تجاههم، بدلاً من تعزيز دورهم على الصعيد السياسي. وللمتصيدين في الماء العكر أقول مباشرة إن هذا ليس مطلباً بالدعوات الانفصالية - بشكل مطلق - بل هو دعوة للمشاركة والانخراط الفعّال في العملية السياسية.
ليست المنطقة العربية تحصيلاً حاصلاً إلا في نظر البعض من أبنائها، وهذا مؤسف؛ حيث يعاني عدد من المواطنين العرب، وبالأخص البعض من فئة الشباب، من لا مبالاة شديدة تصل حدَّ "الاغتراب السياسي"، وهذا قد يكون مبرراً في جزء منه نتيجة الأهوال والويلات التي شهدتها منطقتنا عبر تاريخها، سواء الحديث عموماً أو المعاصر على وجه الخصوص. لكن السؤال الذي يراودني، في زمن المنعطفات الدبلوماسية الشُجاعة التي نشهدها اليوم في المنطقة، أما آن لنا أن ندرك أهمية الرقعة الجغرافية التي نسكنها، خاصة ونحن نرى صراع القوى - الإقليمية منها والدولية - على كسب مناطق نفوذ فيها؟ ألسنا الأجدر والأحق بهذا النفوذ؟ ألم يحن الوقت لنتحصل لأنفسنا على مكان "مستحق" على خارطة القوى والتوازنات الدولية؟ ألن نرفع عن بلادنا "لعنة الحرب" ونحل السلام ونقطف ثماره: تنميةً وعدالةً ورخاءً ومستقبلاً لشبابنا ولأولادنا؟
ابقى على تواصل
القضايا متعمقة يتم تسليمها أسبوعيا.

القضايا ذات صلة: