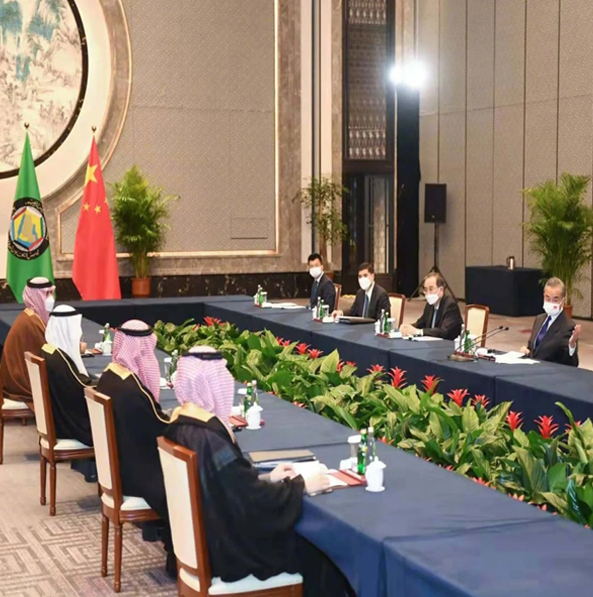مرت التفاعلات الأوروبية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بمنعطفات عدّة قوضت من التماسك الجيوسياسي للكتلة الأطلسية التي تشكّلت وتعمّقت في النصف الثاني من القرن الماضي كوسيلة "وجودية" لاحتواء التمدد الشيوعي في ذلك الوقت.
ولذلك كان منطقياً أن تتباعد مواقف ضفتي الأطلسي بتراجع التهديد الشيوعي، إلا أنه في السنوات الأربع من حكم ترامب أخذ هذا التباعد طابعاً استراتيجياً وصل إلى حد الاشتباك السياسي في بعض الملفات، مثل الخلاف على تمويل حلف الناتو حيث طالبت واشنطن - وبصورة غير دبلوماسية - الدولَ الأوروبية الأعضاء بضرورة رفع إنفاقها العسكري إلى ما لا يقل عن 2٪ من الناتج الإجمالي المحلي. كما برز التناقض الأمريكي الأوروبي في الملف النووي الإيراني، حيث واصلت دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) اعترافها القانوني بالاتفاق رغم الانسحاب الأمريكي منه وفرض عقوبات على الكيانات الحكومية والتجارية التي ستتعامل اقتصادياً مع الجهات الإيرانية المحظورة، فوجدت الدول الأوروبية نفسها في موقف حرج تعيّن عليها فيه الموازنة بين متطلبات حليفها الأمريكي وبين التزامات الاتفاق النووي.
إلا أن أبرز الشروخ عبر ضفتي الأطلسي تمثلت في تراجع دور القيم الديمقراطية في تشكيل السياسات والأهداف، وانكفاء واشنطن عن العمل في إطار التعددية الدولية نحو الأحادية التي تمثلها سياسة "أمريكا أولاً" حيث لم تولي إدارة ترامب الاهتمام الكافي بالمعايير الليبرالية التي أسست الشكل الحالي للنظام الدولي واعتُبرت مرجعاً للتنظيم الاقتصادي والسياسي والثقافي، فهذه المعايير والقيم ليست مجرد طرح فكري برّاق وإنما أيديولوجيا عملية تتيح مزيداً من السيطرة والهيمنة على القرار الدولي.
ولذلك عبّرت دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي عن "فرحتها" بتولي بايدن الحكم، فهو معروف بتوجهاته الديمقراطية التقليدية وتفضيله العملَ الدبلوماسي الرصين على حساب الحلول الفردية غير المنضبطة. ففي كلمة بالبرلمان الأوروبي يومَ تنصيب بايدن، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "إن أوروبا لديها من جديد صديق في البيت الأبيض بعد 4 سنوات طويلة؛ هذا الفجر الجديد في أمريكا هو اللحظة التي كنا ننتظرها منذ وقت طويل".
إلا أن هذا التغيير الرئاسي لا يعني إطلاقاً طيّ صفحة التنافرات الأمريكية الأوروبية؛ إذ أن عوامل التأزيم والتوتر باقية، إلا أن ما سيتغير هو أسلوب التعاطي معها، فعلى الأغلب لن تتبادل بروكسل وواشنطن علناً التصريحات الغاضبة حيال هذه القضية أو تلك، وإنما ستتم هذه المناوشات في مكانها الطبيعي عبر القنوات الدبلوماسية البعيدة عن الإعلام.
وفي هذا الصدد، ستُختبر مدى متانة الروابط الأطلسية في بعض الملفات التي من أبرزها:
1. اختلاف المنظور الجيواستراتيجي حيال الصين وروسيا
تصنف استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الصين وروسيا على أنهما التهديد الأبرز للمصالح الأمريكية. وبعبارةٍ أخرى، يتحدد هدف السياسة الأمريكية في منافسة ومحاصرة هاتين الدولتين في معظم المجالات.
إلا أن للاتحاد الأوروبي موقفاً مغايراً في هذا الصدد، إذ أن العلاقات الصينية الأوروبية لا تزال بمنأى - إلى حدٍ ما - عن التوترات الأمريكية الصينية. ففي الرمق الأخير من ولاية ترامب وقبيل أيام من تنصيب بايدن، تم الإعلان عن "الاتفاق الشامل بشأن الاستثمارات" بين الصين والاتحاد الأوروبي، والذي وصفته مفوضية الاتحاد بأنه "الأكثر انفتاحاً من قبل الصين التي خفّضت العوائق أمام الشركات الأوروبية".
وهذا الاتفاق الذي سيزيد من تدفق الاستثمارات والسلع بين الصين والاتحاد الأوروبي لا يزال مبدئياً، ويستلزم مصادقة دول الاتحاد الأعضاء والبرلمان الأوروبي ليصبح نافذاً. وقد لا يدخل حيز التنفيذ وإنما المراد منه أوروبياً بث رسالة حازمة لواشنطن بأن بروكسل ماضية في سياسة خارجية مستقلة مبتعدةً عن الحليف المتقلب المنفرد في قراراته، ما لم يغير من نظرته "المتكبرة" تجاه الاتحاد الأوروبي "المتمتع" بالمظلة الأمنية الأمريكية.
وقد اختصرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الكثير مما قد يُقال عن مستقبل العلاقات الأوروبية الأمريكية في مقابلةٍ لها مع صحيفة "Financial Times" في يناير 2020، إذ اعتبرت أنه "يتعين على أوروبا أن تصنع دورها الجيوسياسي الخاص بها، وأن تركيز أمريكا عليها في تراجع، وهكذا سيكون الحال مع أي رئيس".

ومثلما ضغطت واشنطن على دول الاتحاد الأوروبي لتحييد شركة "Huawei" عن الاستثمار في البنية التحتية لشبكة اتصالات الجيل الخامس لأسباب أمنية، فإنها تواصل أيضاً ضغوطها لتقليص الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي، فارضةً عقوبات على الشركات العاملة في مشروع "Nord Stream 2"، كما تحاول الإبقاء على أجواء الحرب الباردة باعتماد مفاهيم مثل "الردع النووي" و"الأخطار الوجودية".
وفي كلا الملفين السابقين (الاتفاقية الصينية الأوروبية، ومشاريع نقل الغاز الروسي إلى أوروبا) تلعب ألمانيا الطامحة دوراً مهماً في تنسيق موقف أوروبي متناسق ومضاد للطرح الأمريكي؛ وهو ما قد يفسر القرار الذي اتخذه ترامب في يونيو 2020 القاضي بخفض التواجد العسكري الأمريكي في ألمانيا، والذي أعلن بايدن لاحقاً عن تجميده في خطاب رئيسي خُصّص للسياسة الخارجية ألقاه في فبراير 2021، دون أن يتم توضيح ما إذا كان لهذا التجميد انعكاسات على الأرض عبر إعادة التمركز الأمريكي في ألمانيا كما كان قبل قرار ترامب.
2. العلاقات مع بروكسل بعد "بريكست"
لا تقتصر التنافرات داخل الاتحاد الأوروبي على تفاعلاته الخارجية فقط، وإنما تطال أيضاً العلاقات البينية للدول الأعضاء فيه، ولعل الـ "بريكست" هو أبرز مثال على هذه التباينات الجذرية داخل الوحدة الأوروبية التي لم تكن في السابق "موضعَ شك".
فبتزايد حضور الحركات اليمينية الشعبوية في المشهد السياسي ومطالباتها لحكوماتها بـ "الاستقلال" والانفصال عن الاتحاد؛ يجد النظام الدولي نفسه أمام متغير إن حدث فإنه سيمس بتداعياته حالة الـ "Status Quo" للنظام الدولي الهشة أصلاً.
وهنا تكثر التكهنات حول ما إذا كانت هذه الحركات المجتمعية تُنسَّق مع جهات خارجية رسمية، كروسيا التي يُعتبر رئيسها زعيماً ملهماً ونموذجاً في نظر دعاة الاستقلال، أو حتى أمريكا حيث تَواجَد في السنوات الماضية كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون الاستراتيجية، ستيف بانون، في دول أوروبية تزامناً مع إجرائها لانتخابات تشريعية.
فرغم أن بانون أُقيل في أغسطس 2017 من منصبه الذي شغله لسبعة أشهر، إلا أنه ظل يتمتع بنفوذ جعل بعض المراقبين يصفونه بـ "العراب الدولي" للحركة الشعبوية لما تردد عن تأديته لأدوار داعمة للحركات الانفصالية الأوروبية.
كما أن ترامب أظهر دعمه الصريح لبريطانيا في خضّم مفاوضاتها الشاقة للانسحاب من الاتحاد، واعداً رئيس الوزراء البريطاني المقرَّب منه، بوريس جونسون، بالتوصل إلى اتفاقية تجارية ثنائية "مهمة للغاية ومثيرة للإعجاب" بعد بريكست.
واعتبرت تقارير أوروبية أن واشنطن في عهد ترامب خالفت مبدأً مهماً في دعم وحدة التكتل الأوروبي، عازيةً السبب إلى النزعة الشعبوية الآخذة في التمدد، وإلى رغبة واشنطن في التعامل مع الدول الأوروبية الرئيسية، كلٌ على حدا، وبصورة منفصلة عن الاتحاد، وبذلك تتحرر من القيود الجماعية، وتستطيع فرض شروطها بصورة أسهل نسبياً على هذه الدولة أو تلك.
إلا أن عدم فوز ترامب بولاية ثانية؛ أعاد خلط الأوراق من جديد، فلا الاتفاق التجاري بين واشنطن ولندن سيُعقَد وفق التفاهمات السابقة بين ترامب وجونسون، ولا العلاقات الأمريكية الأوروبية يمكن إعادتها إلى سابق عهدها دون ترميم الروابط الثنائية وتعزيز الثقة المتبادلة أولاً.
وهنا ستفتقد الإدارة الأمريكية حليفها البريطاني الذي عمل كحلقة وصل بين واشنطن وبروكسل، ولا يُتوقع أن تحل دولة أخرى مكان بريطانيا في تأدية هذا الدور الجيوسياسي الحساس، مما يعني أن منطق العلاقات الأمريكية الأوروبية يجب أن يتغير ليتلاءم مع المستجدات الجديدة.
3. تنظيم المعاملات التجارية
بلغت قيمة التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا 1.1 تريليون دولار عام 2019، مما يدل على الترابط الحيوي بين هذين الاقتصادَيْن المعتمديْن على أسواق يحركها الدخل المرتفع للأفراد. وتُنظَّم التحركات التجارية وفق قواعد رأسمالية ثابتة عالجت مختلف القضايا كالتعرفة الجمركية ومعايير الامتثال البيئية.
ونظراً للخلاف على هذه القواعد بين واشنطن وبروكسل، تبادل الطرفان في عهد ترامب فرض الرسوم الجمركية على السلع والخدمات، لينضم الاتحاد الأوروبي إلى الصين وروسيا في تبادل فرض الرسوم.
وسيكون أمام الفريق الاقتصادي لبايدن مهمة صعبة في إعادة "الوفاق" التجاري مع أوروبا إلى سابق عهده. وصحيح أن الالتقاء على قاعدة دعم السوق الحر يعد أسهل مع إدارة يغلب على أعضائها التوجه الليبرالي اقتصادياً، إلا أنه من المبكر الجزم بقدرة فريق بايدن على حل معظم القضايا التجارية الخلافية مع الاتحاد، لأن كثيراً منها لن يترتب على تسويتها منفعة ثنائية متبادلة، ولذلك يسعى كل طرف إلى تغليب مصلحته الخاصة على حساب الآخر ما أمكن ذلك.
كما أن التوجه نحو "الحمائية الاقتصادية" يأتي منسجماً مع توجه شعبي يدعو إلى إيلاء المصالح الوطنية الأولوية ولو كان ذلك بالتصادم مع الاعتبارات العالمية. فمثلاً تشكو الشركات التكنولوجية الأوروبية من هيمنة عمالقة التكنولوجيا الأمريكية على الأسواق دون أن تمتلك القدرات المعرفية والمادية لكسر الاحتكار "القانوني" لهذه الشركات العملاقة.
ويتباحث الاتحاد الأوروبي منذ عام 2018 حول الوسائل الممكنة لفرض "ضريبة رقمية" على الخدمات التكنولوجية العابرة للحدود، وكان البرلمان الفرنسي سبّاقاً بفرضه "نظرياً" لضريبة نسبتها 3٪ على أي شركة رقمية تزيد مبيعاتها العالمية السنوية عن 750 مليون يورو ومبيعاتها داخل فرنسا عن 25 مليون يورو، مما أثار غضب "وادي السيليكون" الأمريكي، فالقرار اعتُبر تمييزياً ضد الشركات الكبرى الأربع المعروفة اختصاراً باسم "GAFA"؛ وهي: Google, Amazon, Facebook, Apple.
"الاستقلالية الأوروبية" إلى أين؟
صُدم الوسط الدبلوماسي والإعلامي في نوفمبر 2019 بتشخيص الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لحالة حلف الناتو بـ "الموت الدماغي" عازياً السبب في الدرجة الأولى إلى غياب القيادة الأمريكية، وهو ما دفعه إلى تجديد دعوته لأوروبا للبدء في العمل كقوة استراتيجية عالمية بصورة مستقلة عن السياسة الخارجية الأمريكية.
ويتطلب تحقيق مثل هذه الاستقلالية أدوات تنفيذية لا تمتلكها الدول الأوروبية، وإدراكاً منها لهذا "القصور" فقد شرعت في تعزيز قدراتها السيادية لا سيما على الصعيد الدفاعي، إذ اقترحت فرنسا في نوفمبر 2018 تشكيلَ جيش أوروبي موحد مهمته حماية القارة من "الصين وروسيا وحتى الولايات المتحدة". ورغم أن هذه الفكرة ليست جديدة وإنما مدرجة في مواد معاهدة الاتحاد الأوروبي، إلا أنها أتت كتعبير عن حالة السخط الأوروبي من الحليف الأمريكي، وفي ظل ظروف دولية استلزمت تضافر جهود الحلفاء لا تباعدهم.
ويتجه الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء صندوق الدفاع الأوروبي لتحقيق نوع من الاستقلالية الأوروبية على صعيد الصناعات الدفاعية، ولتقليل الاعتماد الأوروبي على المظلة الأمنية الأمريكية. فعند تقييم القدرات العسكرية للدول الأوروبية يتبين أن ميزان القوى يُرجّح كفّة كل الفاعلين الدوليين في الساحة الدولية، مما يقلّص من قدرة أوروبا على العمل المنفرد بعيداً عن السياسة الخارجية الأمريكية.
ونظراً لانخفاض قدرة الدول الأوروبية على العمل بصورة مستقلة عسكرياً، فإنها تظل بحاجة إلى الدعم الاستخباري واللوجستي الأمريكي، رغم أن فترة ترامب شهدت بعض العمل الأوروبي المنفرد، مثل عملية مكافحة الإرهاب في مالي، وعملية الإشراف على حظر توريد السلاح إلى ليبيا.
يُضاف إلى ذلك، أن السياسة الخارجية الأوروبية تفتقر إلى "الجرأة" السياسية للعمل عسكرياً خارج قرارات الشرعية الدولية، على عكس واشنطن التي لا تتردد في تنفيذ ضربة استباقية إن دعت الضرورة لذلك.
خلاصة القول؛ حتى لو توافرت الإرادة الجادة للاتحاد الأوروبي للبروز كهوية سياسية سيادية في النظام الدولي، فإن أمامها الكثير من العمل لتكون قادرة على ممارسة تأثير ناجز على مسار الأحداث الدولية. كما أن واشنطن، وبغض النظر عن هوية الرئيس الأمريكي، ستحاول التمسك بعُرى الروابط الأطلسية كي لا تخسر مجالاً حيوياً نافذاً إلى أوراسيا والشرق الأقصى؛ وبالتالي فإنه لا بديل عن هذا التحالف الاستراتيجي في ضوء المعطيات الراهنة.
ومن المتوقع أن تسعى أوروبا إلى تثبيت خصوصيتها السياسية في بعض الملفات التي تتباين وأمريكا في المواقف حولها، ولكن لن ترقى هذه الخصوصية إلى حالة من الانفصال "القاسي"، فعلى الأغلب سينجح بايدن في إعادة المظهر الطبيعي للعلاقات الأوروبية الأمريكية التزاماً منه بوعده في "عودة أمريكا" إلى القيادة الدولية، وهي القيادة التي تتطلب التنسيق مع الحلفاء في إطار من العمل متعدد الأطراف.
وقبل إخضاع الملفات المعقدة لتفاهمات أوروبية أمريكية جديدة، يمكن الشروع بمعالجة بعض الملفات التي تكاد تتطابق حولها وجهات النظر، كالتحدي البيئي، وتحدي توفير لقاح كورونا للجميع بعدالة، والاستغناء عن النزعة القومية في التعامل مع هذه "السلعة" التي ينبغي أن تكون منفعة عالمية متبادلة.
وقد شرع فريق بايدن بالفعل في سد الهوة الأطلسية من خلال تأكيده على دور القيم في رسم ملامح السياسة الخارجية الأمريكية بما يراعي مصالح ومتطلبات الحلفاء دون إقصائهم أو الاستعلاء عليهم.
وسيكشف اجتماع وزراء دول الناتو الذي سيُعقد في فبراير 2021 عن إمكانية إعادة اللُحمة السياسية بين أعضائه، لا سيما أنه سيناقش قضية "متنازع عليها" تتمثل في عملية السلام في أفغانستان، فوفقاً للاتفاق الذي وقعته واشنطن وطالبان؛ تتعهد الولايات المتحدة بسحب كبير لقواتها من هناك بحلول أبريل 2021، في حين يرى الحلف أنه يجب على أعضائه أن يقرروا "معاً" مستقبل مهمتهم، رافضاً المجازفة بانسحاب سريع غير منضبط قبل التوصل إلى اتفاق "محلي" بين طالبان والحكومة الأفغانية، لأن مثل هكذا انسحاب يحمل مخاطر عالية قد تطال تداعياتها الحرب ضد الإرهاب الدولي، مما قد يُفّوت كثيراً من المكاسب التي حقّقها الحلفاء طوال قرابة العقدين من التنسيق المشترك والعمل المكثف.
ابقى على تواصل
القضايا متعمقة يتم تسليمها أسبوعيا.

القضايا ذات صلة:







.jpg)