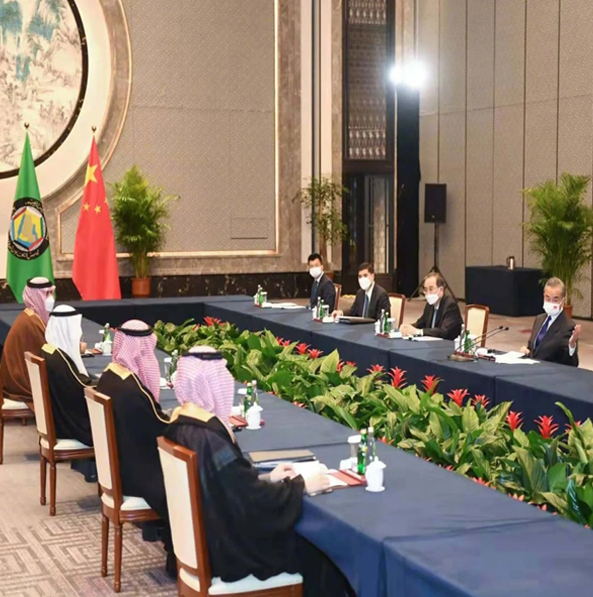رسمياً، باتت الولايات المتحدة في 22 نوفمبر 2020 خارج اتفاقية الأجواء المفتوحة بعد إعلان ترامب في مايو 2020 عن انسحاب واشنطن منها ومرور الفترة القانونية الفاصلة ما بين الإعلان عن الانسحاب ودخوله حيز السريان والمحددة بستة أشهر. وبذلك أصبحت هذه الاتفاقية ثالث معاهدة دولية في مجال الرقابة على الأسلحة تنسحب منها إدارة ترامب بعد خطة العمل الشاملة المشتركة "JCPOA" المعروفة بالاتفاق النووي مع إيران، ومعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى والتي سيتم التطرق إليها في جزء لاحق من هذا التقرير.
ووفقاً لهذه الاتفاقية، يمكن للدول الأعضاء إجراء مسح باستخدام طائرات مزودة بأجهزة قادرة على رصد دقيق لأنواع الأسلحة المنتشرة في الدول الأخرى، ولا يتطلب مثل هكذا إجراء سوى إخطار الدولة التي سيتم تنفيذ طلعات في أجوائها قبل وقت قصير من بدء الرحلة، ويُشترط ألا تكون الطائرة "العسكرية" التي ستنفذ المسح الجوي "مذخّرة" وأن تسلك مساراً محدداً متفقاً عليه.
لا يكمن جوهر هذه المعاهدة في بعدها العسكري بل في بعدها السياسي، فهي تؤدي دوراً بارزاً في زيادة درجة اليقين بين الدول الأعضاء ورفع منسوب الشفافية العسكرية بين القوى الكبرى، فمن شأن سماح دولة لدولة أخرى بدخول "ديار" سيادتها الجوية أن يخفض الشكوك في النوايا حيال القرارات التي قد تتخذها هذه الدولة أو تلك.
وتؤكد الفترة الزمنية التي تم الإعلان فيها عن هذه الاتفاقية على هذه الأهداف، فقد أقرتها 27 دولة عضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "OSCE" عام 1992 بما فيها الولايات المتحدة، في ظل سعي غربي إلى بناء ثقة مع روسيا الفدرالية وتجاوز ذاكرة الحرب الباردة التي بالكاد انتهت في ذلك الحين. وبالفعل نجحت تلك المساعي في تأسيس "أجواء مفتوحة يمكن التيقن منها" في انضمام روسيا عام 2001 إلى المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ فعلياً مطلع العام التالي.
وبالعودة إلى تاريخ "مبدأ المراقبة الجوية المتبادلة" يرجع أول طرح لهذه الفكرة عام 1955 عندما اقترحه الرئيس الأمريكي الأسبق، دوايت أيزنهاور، على رئيس الوزراء السوفييتي آنذاك، نيكولاي بولغين، في مؤتمر جنيف. وبالطبع، فقد جوبه الطلب بالرفض وتصاعد التوتر حول هذا المبدأ ليبلغ ذروته عام 1960 عندما أسقطت قوات الدفاع الجوي السوفيتية طائرةَ التجسس الأمريكية "U-2" على ارتفاع 20 كيلو متراً، وقامت بأسر طيارها.
وهذه المخاوف التي دفعت واشنطن إلى تأسيس "الأجواء المفتوحة"، هي نفسها التي دفعتها إلى الانسحاب منها، فقد عزا مسؤولون أمريكيون في تصريحات وتسريبات إعلامية عديدة هذا الإجراء إلى عدم امتثال روسيا لكل بنود المعاهدة وفرضها قيوداً على بعض النطاقات الجغرافية، فهي بذلك تستفيد من هذه الاتفاقية دون أن تفتح أجواءها بالكامل. فمثلاً، ترفض موسكو السماح بتنفيذ مسح إلى مسافة تقل عن 500 كيلو متراً من كالينينغراد التي تضم أسطول البلطيق والواقعة بين ليتوانيا وبولندا، كما قيدت الطلعات فوق موسكو والشيشان وقرب أبخازيا.
بالطبع لا تُعوّل أي دولة على "الأجواء المفتوحة" في تكوين صورة أمنية استخبارية عمّا يجري أسفل هذه الأجواء، فالأقمار الصناعية والعمليات السيبرانية توفر كمّاً من المعلومات لا يُقارن مع ما يمكن استخلاصه من طلعة سنوية مجدولة مسبقاً. ولكن كما جاء أعلاه في هذا التقرير، تكمن مغازي هذه المعاهدة في بناء جسور الثقة والخروج من أجواء الحرب الباردة التي "أزكمت" النظام الدولي بسباق تسلح مريب.
وفي ظل تحرر واشنطن من معاهدات الرقابة على التسلح، وزيادة منسوب التوتر الدولي؛ يخشى مراقبون من اندلاع سباق تسلح لا يمكن السيطرة عليه. إلا أن ما قد يُهدّئ بعض المخاوف فيما يتعلق بهذه المعاهدة هو عدم وجود أي تصريح أو تسريب من مصادر روسية بأنها سترد بالمثل، فروسيا المنهكة اقتصادياً والباحثة عن ترميم الثقة الأوروبية بسياستها الخارجية بعد أزمة القرم ستسعى إلى "الحصول على ضمانات مؤكدة من أعضاء الاتفاقية الـ 34 المتبقين للوفاء بالتزاماتهم وعلى وجه الخصوص .. أن حلفاء الولايات المتحدة لن ينقلوا لها مواد تصوير الأراضي الروسية"؛ كما أشارت مصادر إلى وكالة "نوفوستي" في تقرير نشرته في نوفمبر 2020.
وبالنظر في بنود المعاهدة، يمكن لدول نقل معلومات طلعاتها إلى دول أعضاء، وبما أن واشنطن لم تعد طرفاً فيها، فمن البديهي تقديم ضمانات لروسيا - من قبل الدول الأعضاء لا سيما حلفاء واشنطن الوثيقين - بأنه لن يكون هناك تبادل لمعلومات هذه الطلعات مع جهات أمريكية. وعليه؛ يُتوقع أن تحافظ هذه المعاهدة على وجودها القانوني ولكن في إطار أوروبي محدد، لحين جلاء طبيعة الإدارة الأمريكية القادمة وتبيان موقفها من معاهدات "الرقابة على الأسلحة" والتي تعد رصيداً استراتيجياً للأمن والسلم الدوليين.
مستقبل اتفاقيات التحكم بالأسلحة
بعد إعلان الرئيس الأمريكي الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة في مايو 2020، عبّر مستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين، عن استعداد الولايات المتحدة للتفاوض مع روسيا والصين حول بناء "إطار جديد للحد من التسلح، بما يتخطى هياكل الماضي التي تعود إلى زمن الحرب الباردة".
ويعيد هذا التصريح التذكيرَ بالتحليلات الأمريكية التي رافقت انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، إذ عكست هذه التحليلات تخوف المجمع العسكري والاستخباري الأمريكي من عدم وجود ضابط قانوني للقدرات العسكرية الصينية المتنامية، فلا يمكن للمخططين الاستراتيجيين الأمريكيين التغاضي عن خطط التحديث العسكري الصينية الطامحة للوصول إلى حالة من التكافؤ العسكري مع أمريكا في غضون العقود الثلاثة القادمة أو ربما التفوق عليها، فقانونياً الصين ليست مقيدة باتفاقيات التحكم بالأسلحة على غرار الولايات المتحدة، مما يتطلب وفق المنظور الأمريكي إدماجَ الصين في أنظمة الحد والتحكم والنزع الخاصة ببعض صنوف الأسلحة، وإذا لم ترغب الصين في هذا الاندماج، فعلى الولايات المتحدة إعادة النظر في الاتفاقيات الحالية، كما يرى هؤلاء المخططون الأمريكيون.
وتعد اتفاقية "New START" من أهم الاتفاقيات في هذا المجال، وجاء التوقيع عليها بعد انتهاء العمل بـمعاهدة "START" التي دخلت حيز التنفيذ في 1994، حيث وقّع كل من الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، والروسي، دميتري ميدفيديف، في أبريل 2010 اتفاقية ثنائية تضمنت تحديد عدد منصات الإطلاق النووية الاستراتيجية المنصوبة بـ 700 منصة كحد أقصى وعدد الرؤوس النووية بـ 1550 كحد أقصى.

وينتهي العمل بهذه الاتفاقية في الخامس من فبراير 2021، أي بعد قرابة نصف شهر من تولي بايدن صلاحياته الرئاسية ما لم تحدث مفاجئة انتخابية. ونظراً لكونها آخر اتفاقية رئيسية تجمَع بين أمريكا وروسيا في هذا المجال، يتفق خبراء الأمن الدولي على ضرورة تمديدها بصورتها الحالية، أو تمديدها لمدة عام لحين التفاوض على اتفاقية جديدة تعالج التحفظات وتكون لبنة أولية لإطار قانوني يضم القوى النووية الرئيسية الأخرى كالصين وبريطانيا.
وتُظهر خلفيات المسؤولين الذين اقترح بايدن تعيينهم لشغل المناصب العليا في الإدارة الأمريكية المقبلة، الحرصَ على احترام العمل الدبلوماسي متعددَ الأطراف، مما يعني أن السياسة الخارجية الأمريكية ستعود تدريجياً للعمل مع الحلفاء والخصوم دون اللجوء إلى الخطوات الأحادية، إلا للضرورات الملحّة المقترنة باعتبارات الأمن القومي والمصالح الحيوية الأمريكية.
وكثيراً ما أظهرت تصريحات بايدن ومسؤولي إدارته المرشحين احترامَ القواعد المحددة للتفاعلات الدولية داخل بنية النظام الدولي، وعلى رأسها عدم التساهل في الانسحاب من الاتفاقيات متعددة الأطراف وذات الثقل الاستراتيجي الأمني.
ولذلك يُرجَّح تمديد العمل باتفاقية "New START" بصيغة أو بأخرى، وقد تتضمن الاتفاقية الجديدة ملحقاً خاصاً ثنائياً أو ثلاثياً - إذا ما تم إدماج الصين - بحيث يحوي بنوداً تحاكي اتفاقية "الأجواء المفتوحة" واتفاقية "الأسلحة النووية متوسطة المدى"، وهو ما قد يساهم في إعادة ضبط الثقة الاستراتيجية بين الفرقاء.
ولا يعني ذلك أن نهج بايدن سيكون انقلاباً مضاداً على نهج ترامب، فسياسة "أمريكا أولاً" ليست بدعة جاءت بها إدارة ترامب كما يسوّق البعض وإنما هي خيار المؤسسة "Establishment" التي سئمت من تحمل كلف لا تجلب عائد مقابِل، وبصورة عبثية لا تخدم المصالح الأمريكية. ففي عهد باراك أوباما تم تنفيذ انسحاب استراتيجي للقوات الأمريكية من العراق وكان هناك محاولة لتنفيذ انسحاب مماثل من أفغانستان، وفي عهده أيضاً تم مطالبة دول الناتو بزيادة الإنفاق الدفاعي بما يتناسب مع الناتج الإجمالي المحلي لكل دولة، وتم صياغة سياسة محور- آسيا Pivot to Asia"، وهذه القضايا الثلاث انخرطت إدارة ترامب في تفاصيلها، ووسمت السنوات الأربع من التوترات التي رافقت السياسة الخارجية الأمريكية.
إذاً؛ سيطبّق بايدن سياسة "أمريكا أولاً" ولكن بأسلوب دبلوماسي متعدد الأطراف وليس بأسلوب أحادي يعزل أمريكا عن قيادة وتوجيه النظام الدولي، وهو ما يتطلب حصافة سياسية تصون سمعة واشنطن كشريك مسؤول يلتزم بالاتفاقيات الدولية لا سيّما تلك المتعلقة بمراقبة التسلح. فلو استمرت الولايات المتحدة في انسحاباتها، لن يبقى في جعبتها ما تطالب خصومها ومنافسيها للالتزام به، لأنها أصلاً لم تعد طرفاً في هذه الاتفاقيات المنسحبة منها.
رغم ذلك لا يمكن الجزم بتمديد إدارة بايدن العملَ بـ "New START" فقد يتم الانسحاب منها كامتداد للاضطرابات التي مرّت بها العلاقات الأمريكية الروسية في ولاية أوباما الثانية تأثراً بأزمة القرم، والانخراط العسكري الروسي في سوريا، والتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016 بصورة رجّحت كفّة المرشح الجمهوري، دونالد ترامب.
وإلى حين انقشاع ضبابية المشهد في الولايات المتحدة، على الخبراء المهنيين الموضوعيين حثَّ مختلف القوى الكبرى على الالتزام بنظام رقابة على التسلح، فالتوترات السياسية الراهنة لا تحتمل سباق تسلح لا يمكن كبح جماحه ومن شأنه أن يُعقّد المخاوف والتصورات السلبية غير البنّاءة.
ابقى على تواصل
القضايا متعمقة يتم تسليمها أسبوعيا.

القضايا ذات صلة: